على الرغم من توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مايو 2025، فإن العلاقات بين البلدين لا تزال تشهد حالة من التهدئة الحذرة، بعد سنوات من التوترات المتصاعدة التي اتسمت بجولات متبادلة من الرسوم الجمركية، والقيود التقنية، والاتهامات المتكررة بالممارسات التجارية غير العادلة. وفي سياق تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد هشاشة سلاسل الإمداد، سعى الطرفان إلى احتواء التصعيد عبر إعلان هدنة تجارية جديدة، تهدف إلى تجميد الإجراءات التصعيدية، وفتح قنوات تفاوض انتقائية حول عدد من الملفات الحيوية.
ومع ذلك، فإن هذه الهدنة لا تعبر عن نهاية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بقدر ما تعكس لحظة توازن مؤقت بين الحاجة إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، والرغبة في الإبقاء على أدوات الضغط الاستراتيجي، فجوهر النزاع بين واشنطن وبكين يتجاوز الخلل في الميزان التجاري، ليكشف عن تنافس بنيوي طويل الأمد يتمحور حول السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي في نظام دولي يشهد تحركات متسارعة.
وفي هذا السياق، تهدف هذه الورقة إلى تحليل مستقبل الهدنة التجارية الراهنة، من خلال تقييم العوامل البنيوية والظرفية التي تُحدد مسارها، ورصد السيناريوهات المحتملة لتطورها، وذلك في ضوء استمرار التنافس الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين القوتين العظميين.
أولًا: أبعاد السياسة التجارية الأمريكية في مواجهة الصين.. بين الحماية والتصعيد
تعود جذور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إلى ما قبل عام 2018، غير أن ملامحها اتضحت بشكل أكثر حدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (2017–2021)، حيث تبنت إدارته مقاربة قائمة على “أمريكا أولًا”، ركزت على تقليص العجز التجاري، وحماية الصناعات الأمريكية من ما اعتبر ممارسات تجارية غير منصفة من قبل الصين، وقد تمثلت أبرز أدوات هذه المقاربة في فرض رسوم جمركية متصاعدة على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، خارج الأطر التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، مما شكل تحولًا نوعيًا في سياسة التجارة الخارجية الأمريكية.
وفي مطلع ولاية ترامب الثانية (2025–2029)، تصاعدت حدة الحرب التجارية بشكل ملحوظ، ففي فبراير 2025، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين، مدفوعة بمخاوف من الإغراق الصناعي واستخدام الدعم الحكومي الصيني لتعزيز تنافسية هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية. ثم تبعتها إجراءات إضافية في مارس شملت رفع الرسوم الجمركية إلى 25% على أشباه الموصلات، و25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي. وبحلول أبريل 2025، بلغت القيمة التراكمية للواردات الصينية الخاضعة للتدابير الجمركية الأمريكية نحو 1.2 تريليون دولار، تركزت معظمها في القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة المدرجة ضمن مبادرة “صُنع في الصين 2025”.
وتستند السياسة التجارية الأمريكية في هذا السياق إلى مجموعة من الأهداف المتداخلة. فمن ناحية، تسعى واشنطن إلى تقليص العجز التجاري الثنائي، الذي بلغ نحو 375.6 مليار دولار في عام 2023. ومن ناحية أخرى، تركز على حماية سلاسل التوريد الحيوية، وتعزيز أمنها التكنولوجي، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، كما تهدف إلى الحد من الاعتماد على الواردات من الصين في مجالات تعتبرها استراتيجية، في ظل تحوّلات أوسع في مفاهيم الأمن القومي الاقتصادي.
وقد جاء اتفاق تجاري مؤقت في مايو 2025 ليشكل محاولة لاحتواء التصعيد وتثبيت نوع من التهدئة المؤقتة. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 125% إلى 10% لمدة 90 يومًا، كما خفضت الرسوم على الشحنات الصغيرة (أقل من 800 دولار) ضمن آلية “دي-مينيميس” التي كانت خاضعة سابقًا لتعرفة تبلغ 120%. في المقابل، التزمت بكين بخفض الرسوم على السلع الأميركية إلى 10%، ورفعت الحظر عن طائرات “بوينغ”، مع إبداء استعداد مبدئي لتخفيف القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، التي تُعد من مدخلات الصناعات الاستراتيجية الأميركية.
ومع ذلك، لم تمنع هذه التهدئة المؤقتة من استمرار التداعيات الاقتصادية المرتبطة بسياسات الحماية المتبادلة، والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف بعض السلع المستوردة داخل السوق الأمريكية، وزيادة معدلات التضخم في قطاعات محددة بنسبة تراوحت بين 15% و20%، إلى جانب اتجاه عدد متزايد من الشركات الأمريكية نحو إعادة توطين سلاسل إمدادها في دول مثل فيتنام، الهند، والمكسيك. وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن نحو 37% من الشركات الكبرى أعادت هيكلة جزء من شبكاتها الإنتاجية بعيدًا عن الصين خلال عامي 2024 و2025.
ثانيًا: مؤشرات متبادلة على خرق الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة
توالت جملة من المؤشرات المتعددة إلى أن كلًا من واشنطن وبكين اتخذ إجراءات أحادية أو متبادلة تعد انتهاكًا لبنود الهدنة التجارية الموقعة بينهما في مايو الماضي، سواء عبر توسيع القيود الجمركية والتكنولوجية، أو من خلال استخدام أدوات ضغط سياسي واقتصادي خارج إطار الاتفاق، ولعل أبرز هذه المؤشرات ما يلي:
-
فرض إجراءات تقييدية جديدة على صادرات المعادن النادرة: اتهمت الصين واشنطن بعرقلة تدفق صادراتها من المعادن النادرة، رغم كونها موردًا استراتيجيًا للعديد من الصناعات الأمريكية، خاصة في قطاع الدفاع والرقائق، كما رُصد تباطؤ متعمد في منح التراخيص للاستيراد من قبل الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته بكين إخلالًا بشروط التفاهمات الأخيرة في جنيف. على الجانب الاخر اتهم مسؤولين أمريكيين الصين بتخفيض وتيرة تصدير عناصر نادرة تستخدم في الصناعات الدفاعية والطيران، مما خالف تعهدها بضمان “تدفق طبيعي وغير مقيد” لهذه المواد الحيوية.
-
توسيع القيود التكنولوجية: فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا جديدة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبرمجيات الخاصة بتصميم الرقائق الإلكترونية، حيث شملت الإجراءات شركات صينية لم تكن مدرجة سابقًا في “قائمة الكيانات المحظورة”، مما يعد تصعيدًا غير متفق عليه في الهدنة.
-
تشجيع السياسات الحمائية الداخلية: أعلنت واشنطن عن حوافز حكومية جديدة بمليارات الدولارات لدعم الصناعات المحلية في مجال البطاريات والسيارات الكهربائية، ضمن قانون “التنافس الاستراتيجي”، مما اعتبرته الصين منافسة غير عادلة. وذلك في الوقت الذي ضاعفت فيه بكين من دعمها المالي والتقني لشركاتها العاملة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
-
تصريحات سياسية تربط الاقتصاد بالأمن: صدر عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تربط بشكل مباشر تخفيف القيود التجارية المفروضة على الصين بمدى تعاون بكين في ملفات جيوسياسية حساسة، وعلى رأسها قضية تايوان، والتهديدات السيبرانية، والوجود العسكري في بحر الصين الجنوبي. في المقابل صعدت بكين من لهجتها الدبلوماسية تجاه واشنطن، وهددت بإعادة النظر في تعاونها في ملفات عالمية مثل التغير المناخي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، حال استمرار القيود التجارية، كما استخدم الإعلام الصيني الرسمي هذه التصريحات الأمريكية لتأكيد ما تعتبره “نوايا غير صادقة” من الجانب الأمريكي، متهمة واشنطن بـ”الخلط المتعمد” بين الملفات، بما يفرغ الهدنة التجارية من مضمونها العملي ويحولها إلى أداة تكتيكية بحتة.
-
حجب الشفافية حول سلاسل التوريد: اتهمت شركات أمريكية السلطات الصينية بإجراء تغييرات مفاجئة على قواعد التصدير والاستيراد، شملت فرض رسوم جمركية جديدة وتعقيد الإجراءات التنظيمية دون إشعار مسبق، ما أربك سلاسل التوريد وأثر سلبًا على بيئة الأعمال. في المقابل، اتهمت بكين واشنطن باتباع ممارسات مماثلة، أبرزها فرض قيود غامضة على منح التراخيص لواردات صينية حساسة، والتوسع في لوائح الكيانات المحظورة دون شفافية، وهو ما اعتبرته الصين انعدامًا للتكافؤ في الالتزامات وخرقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ثالثًا: ماذا لو انهارت الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟
إن انهيار الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيشكل نقطة تحول استراتيجية في بنية النظام الدولي، تمتد تداعياته إلى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والسياسة النقدية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والناشئة، ويمكن تحليل هذه التداعيات وفق أربع دوائر مترابطة:
-
التداعيات الاقتصادية المباشرة: في حال انهيار الاتفاق التجاري، ستعود السياسات الحمائية بقوة، مع فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و50% على سلع رئيسية مثل الإلكترونيات، السيارات، والمنتجات الزراعية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك وتراجع القدرة الشرائية في الولايات المتحدة، إلى جانب ضغوط تضخمية ملحوظة. أما في الصين، فقد تتراجع الصادرات بنحو 20%، مما يضغط على النمو الاقتصادي ويرفع البطالة. كما ستتضرر سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات تعتمد على المكونات الصينية، مما يدفع الشركات إلى نقل خطوط إنتاجها نحو دول مثل الهند والمكسيك، رغم محدودية الكفاءة والبنية التحتية مقارنة بالصين.
-
التأثيرات الجيوسياسية والمالية العالمية: ستتسارع الحرب التكنولوجية مع توسيع واشنطن لقيود تصدير الرقائق والتقنيات المتقدمة، في حين تسعى بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تحديات الابتكار. ماليًا، قد تلغي الولايات المتحدة امتيازات تجارية للصين وتفرض قيودًا على الاستثمارات، بينما ترد بكين بتوسيع استخدام اليوان الرقمي وإنشاء بدائل لـ SWIFT ضمن مسار فك الارتباط المالي، وهذا التصعيد قد يفتح المجال لحرب عملات، إذا خفضت الصين قيمة اليوان لدعم صادراتها، ما قد يقابله تشدد أمريكي في السياسة النقدية، ويزيد من اضطراب الأسواق العالمية.
-
التوترات الأمنية والصراعات غير المباشرة: سيصاحب الانهيار التجاري تصعيد في الملفات الأمنية، خاصة في تايوان وبحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، ورد صيني محتمل بإجراءات ميدانية أو عقوبات مضادة، كما قد تندلع “حروب وكالة اقتصادية”، تضغط فيها واشنطن على حلفائها لتقليص علاقاتهم مع شركات تكنولوجية صينية كبرى، فيما قد تستخدم بكين المعادن الأرضية النادرة كورقة ضغط حيوية في الصناعات المتقدمة.
-
تداعيات على دول الجنوب العالمي: ستواجه الدول النامية، وعدد من القوى الإقليمية الناشئة، ضغوطًا متزايدة للاصطفاف مع أحد المعسكرين، ما يهدد بهشاشة سياسات الحياد الاستراتيجي التي تتبناها بعض هذه الدول، كما أن الانقسام بين واشنطن وبكين سيعمق أزمة الديون في الدول المثقلة بالاقتراض من الصين، مثل زامبيا وسريلانكا، التي قد تحرم من التمويل الغربي أو تواجه تعقيدات في إعادة الهيكلة المالية، ومن المحتمل أن تتراجع تدفقات الاستثمار والتجارة، ما يفاقم حالة الركود في العديد من الاقتصادات النامية التي تعتمد على الاستقرار العالمي لتحقيق النمو.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل الاتفاقية التجارية
-
السيناريو الأول: استمرار الهدنة مع تفاوض انتقائي (الأكثر ترجيحًا): يستند هذا السيناريو إلى الحفاظ على التهدئة التجارية الراهنة بين بكين وواشنطن، دون التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي، حيث تلتزم الأطراف بشكل نسبي ببنود الاتفاق الموقع في مايو 2025، مع استمرار قنوات التفاوض في ملفات محددة مثل الرقائق والمعادن النادرة، وذلك في الوقت التي ستظل بعض القيود الجمركية والتكنولوجية قائمة، لكن من دون تصعيد إضافي. في المقابل، تتوسع الحرب الباردة التقنية بشكل غير معلن، وتزداد محاولات الفصل التدريجي في سلاسل التوريد الحساسة. يؤدي هذا السيناريو إلى استقرار جزئي في الأسواق وتجنب صدمة اقتصادية عالمية، لكنه لا يحقق عودة إلى مرحلة ما قبل 2018 من التكامل التجاري.
-
السيناريو الثاني: الانفصال التجاري المنظم (محتمل): يرجح هذا السيناريو تطورًا بطيئًا نحو فك الارتباط التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بصورة مدروسة وتدريجية، حيث تبدأ واشنطن في تعزيز الشراكات الإقليمية مثل إطار IPEF، بينما توسع بكين حضورها في تكتل RCEP وتدعم مبادرات الاعتماد على الذات، ويتشكل تدريجيًا نظامان اقتصاديان عالميان شبه منفصلين: أحدهما تقوده الصين في آسيا والجنوب العالمي، والآخر بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب. يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع في العولمة التقليدية، وازدياد التنافس على النفوذ في الأسواق النامية، ما يعيد تشكيل بنية النظام التجاري العالمي على أسس ثنائية القطب.
-
السيناريو الثالث: انهيار الاتفاقية وتصاعد الحرب التجارية (الأقل ترجيحًا): يفترض هذا السيناريو فشل الهدنة الراهنة بسبب خلافات هيكلية في قضايا مثل دعم الصناعات التكنولوجية، الملكية الفكرية، أو الأزمة الجيوسياسية في تايوان، حيث تعود الرسوم الجمركية الكاملة على السلع المتبادلة (بما يتجاوز 50%)، وتُضاف شركات جديدة إلى “قوائم الكيانات المحظورة”، مما يؤدي إلى تعطيل واسع في التجارة العالمية، وتضرر سلاسل الإمداد، كما تتفاقم الأزمة بتضخم عالمي جديد، وركود محتمل في الاقتصادات النامية. في هذا الإطار، تدخل العلاقات التجارية بين القوتين مرحلة صدام مفتوح، تتراجع فيه مبادئ التجارة الحرة لحساب السياسات الحمائية والمواجهة الجيو-اقتصادية.
وختامًا يمكن القول..
تمثل الهدنة التجارية الموقعة بين الولايات المتحدة والصين في مايو 2025 مظهرًا من مظاهر التوازن المرحلي بين قوتين اقتصاديتين تتنازعان على صياغة قواعد النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من الطابع المؤقت لهذا الاتفاق، فإنه يعكس إدراكًا متبادلاً لخطورة التصعيد غير المنضبط على الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل هشاشة سلاسل الإمداد وتباطؤ معدلات النمو العالمي، غير أن تحليل المؤشرات الفعلية منذ توقيع الهدنة يُظهر أن الالتزام بها ظل نسبيًا ومحدودًا من كلا الطرفين، حيث تواصلت الإجراءات الحمائية والتقييدات التقنية، مصحوبة بخطابات سياسية تعزز مناخ انعدام الثقة، ويفضي هذا السياق إلى سيناريوهات متعددة، تتراوح بين تثبيت الوضع القائم والتوجه نحو فك ارتباط تدريجي، أو حتى العودة إلى مواجهة تجارية مفتوحة، بما يحمله ذلك من انعكاسات على بنية الاقتصاد الدولي.
في ضوء هذه المعطيات، تبرز ضرورة تبني الدول النامية، لاستراتيجيات تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز التكامل الإقليمي، والانخراط الفاعل في سلاسل القيمة البديلة، كما يتطلب الأمر مواكبة التحولات التقنية واللوجستية الجارية عالميًا، من أجل تعظيم المكاسب وتقليص الهشاشة في مواجهة التحولات الهيكلية الجارية في النظام التجاري العالمي.
No Result
View All Result





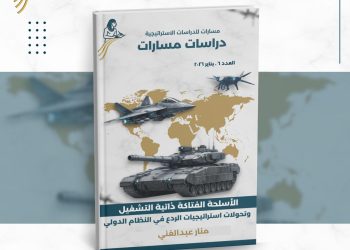


برافو تحليل جميل جدا
بالتوفيق