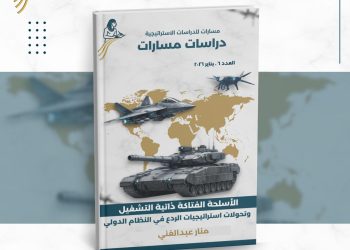رؤى إيرانية- رؤية الصحف ومراكز الفكر الإيرانية لمستقبل طهران في مرحلة ما بعد الحرب مع إسرائيل
تشهد الساحة الفكرية والإعلامية الإيرانية في أعقاب الحرب مع إسرائيل حالة من الاهتمام المتزايد بمستقبل إيران وتحديات المرحلة المقبلة، حيث تتناول المقالات التي صدرت مؤخرًا في الصحافة الإيرانية جوانب متعددة لهذه المرحلة، مع تركيز خاص على قضايا الوحدة، وتعزيز الهوية الوطنية والدينية المتكاملة، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر الاختراق والتطرف.
كما تؤكد هذه الكتابات على ضرورة تجديد الرواية الوطنية وأهمية تعزيز المرونة المجتمعية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ومن الملاحظ في الخطاب الفكري الإيراني بعد الحرب، تصاعد التأكيد على أن الهوية الوطنية الإيرانية ليست متناقضة مع البعد الديني والمذهبي، بل تتكامل معه بعمق. ففي هذا السياق، يشير آية الله محمد غروي إلى أن التشيع في إيران لم يكن يومًا ظاهرة مستوردة أو مفروضة، بل هو خيار ثقافي واجتماعي وتاريخي متجذر، مما يجعل محاولات فصل الهوية “الإيرانية” عن “الشيعية”، سواء من الداخل أو الخارج، تفقد فهمًا جوهريًا لطبيعة الهوية المركبة لإيران.
وفي هذا السياق، يتناول التقرير تحليلات متعددة تعكس التنوع في وجهات النظر داخل المشهد الإعلامي والفكري الإيراني، مع تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تشغل الرأي العام والمفكرين، كما يركز على السياسات المقترحة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الحرب. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير الخطوات التي تقترحها مراكز الفكر الإيرانية لتعزيز الاستقرار الداخلي وتجديد الرواية الوطنية بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية.
أولًا: الوحدة الوطنية: من شعار إلى استراتيجية
تبرز الصحف ومراكز الفكر الإيرانية في تحليلاتها الراهنة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل مؤشرات واضحة على تماسك الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، خلافًا للتوقعات التي رأت أن الصراع سيؤجج الاحتجاجات الداخلية، وتشير هذه التحليلات إلى أن الشعب الإيراني بمختلف أطيافه وفئاته يقف موحدًا في دعم وحدة البلاد والحكومة، مؤكدين على أن التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والأمنية تتطلب تعزيز وحدة وطنية تتجاوز الشعارات لتصبح استراتيجية عملية، وفي هذا السياق، يؤكد الكاتب أكبر منتجبي، رئيس تحرير صحيفة “سازندگي”، أن الوحدة الحقيقية لا تتحقق بإلغاء الاختلافات، بل عبر قبولها وتوجيهها ضمن إطار من الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية، مشددًا على أن بناء الثقة بين الشعب والمسؤولين ووضع الأهداف الوطنية فوق المصالح الفئوية أصبح ضرورة حتمية للبقاء في بيئة إقليمية متقلبة، كما تحذر هذه الرؤى من مخاطر إقصاء النخب الإصلاحية والمستقلة، والتخوين السياسي الذي يقوض الثقة الوطنية ويفتح المجال أمام خصوم الداخل والخارج لاستغلال الانقسامات.
ثانيًا: تجديد الرواية الوطنية: صوت جديد لإيران
تناولت الصحف ومراكز الفكر الإيرانية بشكل واسع قضية ضعف الإنتاج الإعلامي الوطني، مشيرة إلى التحديات التي تواجه إيران في حرب الروايات الإعلامية، خاصة في مواجهة القنوات الفارسية الفضائية مثل “إيران إنترناشونال”، التي تُعتبر من أبرز وسائل الإعلام المعارضة للنظام الإيراني وتبث من خارج البلاد، وتؤكد التحليلات أن السيطرة على السرديات والروايات باتت أكثر تأثيرًا من مجرد عرض الحقائق، مما يستدعي من إيران، بحضارتها العريقة وتاريخها الغني، تطوير رواية وطنية جديدة حية وصادقة وشاملة، لا تعتمد على الكليشيهات، بل تعكس الحقائق والأمل والكرامة الوطنية.
ويشير الكاتب أكبر منتجبي إلى أن بناء الرواية الوطنية لا يقتصر على استخدام الشعارات، بل هو توجيه ذهني شامل للأمة، داعيًا إلى إطلاق وسائل إعلام جديدة ومتنوعة، مثل القنوات التلفزيونية الخاصة، التي تعبر عن أصوات متعددة تتوحد تحت اسم إيران. بدوره، يرى الكاتب الصحفي شمس الواعظين أن الانتصار العسكري يجب أن يُتوج بانتصار في حرب الروايات، وهو ما لم يتحقق بعد بسبب ضعف القدرات الإعلامية الإيرانية، مشيدًا بالقيادة الدبلوماسية الحكيمة للسيد عراقجي، الذي نجح في الحفاظ على حالة من عدم اليقين لدى الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما تؤكد مقالات الرأي على ضرورة إنتاج “رواية وطنية جديدة” قادرة على استلهام الأجيال الجديدة، وتمثيل كافة شرائح المجتمع الإيراني من نساء وشباب ونخب وطبقات عاملة وأقليات. فإما أن تتبلور هذه السردية الموحدة لتعكس الإرادة الجمعية الوطنية، أو تترك فراغًا يُملأ بسرديات مضللة من معارضين داخل وخارج البلاد يسعون لتشويه صورة إيران التاريخية.
ثالثًا: تعزيز العلاقة بين الدولة والشعب: ضرورة وطنية
وفق العديد من الكتاب الإيرانيين، ومنهم محمد رضا عارف أن سياسات وإجراءات العقود الأربعة الماضية للحفاظ على التماسك الوطني في إيران بحاجة إلى إعادة النظر، حيث يؤكد هذا التوجه على أهمية عودة الدولة إلى الشعب كأولوية قصوى لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الأمن القومي. وبحسب محللين داخل إيران، يتمثل المكسب الأكبر في هذه الحرب في مشهد التلاحم الوطني: الشعب، بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية، اصطفّ خلف مؤسساته، دفاعًا عن الأرض والهوية، وهو ما أسماه البعض بـ”غنيسازی اتحاد ایرانیان” أو “تخصيب وحدة الإيرانيين”، لكن هذا “التحصين الداخلي” الذي تحقق في لحظة الأزمة، ليس مكسبًا مضمونا أو ثابتًا؛ بل يتطلب – كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان– تحولات جوهرية في نمط الحكم، وإعادة ترميم الثقة، وإدماج المواطنين في عملية صنع القرار.
رابعًا: تجديد القوة الإيرانية: من أين نبدأ؟
في مقاله الافتتاحي، يطرح أستاذ علم الاجتماع حمزة نوذري سؤالًا مركزيًا يشغل النخبة الفكرية والسياسية في إيران: من أين نبدأ لتجديد القوة الإيرانية بعد الحرب؟ ويستعرض من خلاله جملة من الرؤى المتباينة التي تعكس الجدل الداخلي حول أولويات مرحلة ما بعد الأزمة.
تبدأ أولى هذه الرؤى من المقاربة الأمنية، حيث يرى البعض أن تعزيز القوة العسكرية هو السبيل الوحيد لترسيخ مكانة إيران وردع خصومها، وجعلها شريكًا لا غنى عنه في أي تحالف إقليمي أو دولي. في المقابل، تطرح رؤية أخرى أولوية الاقتصاد، باعتبار أن الرفاهية والاستقرار الاقتصادي هما أساس لأي قوة وطنية مستدامة.
أما الرؤية الثالثة، فهي الدبلوماسية، والتي تدعو إلى مراجعة السياسة الخارجية على أسس أكثر براغماتية، عبر تخفيف التوترات والانفتاح المحسوب على العالم، وهناك من يذهب أبعد، ليؤكد أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، أي من إصلاحات اجتماعية تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز التضامن الوطني، في ظل دعوات واضحة للمساءلة والشفافية.
وفي محاولة للجمع بين هذه المسارات، يقدم نوذري ما يُعرف بـالرؤية المختلطة، التي ترى أن النهوض الشامل يتطلب توازنًا بين أدوات القوة: عسكرية، اقتصادية، دبلوماسية، واجتماعية. ويشدد على ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء نمط حكم جديد يرتكز على العقلانية السياسية والانفتاح على الرأي العام.
لكن الأهم من كل ذلك، كما يختم نوذري، هو إطلاق حوار وطني واسع ينطلق من الفن والموسيقى والثقافة الشعبية، باعتبارها أدوات فاعلة لتعبئة التضامن الجماعي، بعيدًا عن البيروقراطية المغلقة. فالقوة – كما يرى – لا تُبنى فقط بالخطط الخمسية أو الخطابات الرسمية، بل بالمشاركة الشعبية الواسعة التي تُحوّل لحظة ما بعد الحرب إلى فرصة للتجديد الشامل.
خامسًا: الردع الصاروخي وتغيير توازن القوى
وفي أحد أبرز التحليلات الصادرة بعد الهجوم الإيراني، يشير الكاتب شمس الواعظين إلى أن الضربة الصاروخية الإيرانية كشفت عن تحول نوعي في ميزان الردع العسكري في المنطقة، ويؤكد أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بالمستوى العالي من الدقة والتأثير الذي أظهرته الترسانة الصاروخية الإيرانية، ولا سيما صاروخ خيبر شكن-2، الذي ألحق أضرارًا مباشرة وجسيمة بعدد من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وبحسب التحليل، فإن منظومة القبة الحديدية، التي لطالما عُدت خط الدفاع الأول لإسرائيل، تعرضت لانهيار في الأداء، في حين لم يُظهر نظام “شاؤول” أي فعالية تُذكر في التصدي للموجات الصاروخية. كما سُجّلت اختراقات ضد نظام ثاد الأمريكي، ما يُعد تطورًا لافتًا بالنظر إلى التصنيف المتقدم لهذه المنظومة عالميًا.
ويرى التحليل أن هذه الأضرار تتجاوز البعد التكتيكي، وتمس الأسس الاستراتيجية لمنظومة الدفاع الإسرائيلية، الأمر الذي يفرض إعادة هيكلة واسعة وتخطيطًا طويل الأمد لاستعادة الجاهزية. ونتيجة لذلك، فإن قدرة إسرائيل على المبادرة أو شنّ هجوم ضد إيران في المدى القريب باتت محل شك كبير، ليس فقط بسبب الخسائر التقنية، بل أيضًا بفعل الضرر النفسي والسياسي الذي لحق بصورة الردع الإسرائيلية.
سادسًا: التحديات التي تواجه إيران بعد الحرب مع إسرائيل
رغم ما تحقق من نتائج ميدانية في الحرب مع إسرائيل، إلا أن إيران تقف اليوم أمام مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها في مرحلة ما بعد الحرب، سواء على الصعيد الداخلي أو في علاقاتها الإقليمية والدولية، ما يستدعي معالجة واقعية ومتدرجة لضمان الاستقرار.
1- الجبهة النفسية: الأثر غير المرئي للصراع المسلح
يرى عدد من المحللين والخبراء، ومنهم الدكتورة إلهام فخاري، أخصائية علم النفس، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه إيران بعد الحرب يتمثل في الآثار النفسية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال، وتشير فخاري إلى أن الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب قد تؤدي إلى اضطرابات مثل القلق والتوتر والشعور بعدم الأمان، وهو ما يتطلب برامج دعم نفسي جماعي، وتفعيل آليات مجتمعية لإعادة بناء التماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق، تشير فخاري إلى أهمية الرعاية النفسية الجماعية، وتفعيل مساحات الحوار، والدعم المجتمعي، معتبرة أن مفهوم «إعادة الإعمار» لا ينبغي أن يقتصر على إصلاح البنية التحتية، بل يجب أن يشمل أيضًا ترميم البنية النفسية والاجتماعية، باعتبار الإنسان محور الاستقرار والتعافي الحقيقي.
2- مخاطر الاختراق: هدوء يسبق العاصفة
يرى محللون أن أخطر ما تواجهه إيران في مرحلة ما بعد الحرب لا يتمثل في التهديدات الخارجية المباشرة، بل في ما يُعرف بـ”الاختراق” أو “النفوذ” الذي يستهدف الداخل. ويُحذر الكاتب منتجبي من هذا النوع من الاختراق الذي لا يأتي عبر الحدود، بل يتسلل من داخل دوائر الثقة، متخفّيًا خلف شعارات الولاء والدفاع عن القيم. ويصف منتجبي هذا النمط من النفوذ بأنه الأخطر، لأنه لا يُطلق النار، بل يزرع الشك ويُضعف رأس المال الاجتماعي، ويؤدي إلى تآكل الثقة العامة، وتعميق الاستقطاب، وإقصاء الأصوات المعتدلة التي تشكل صمّام الأمان في أي مجتمع.
ووفق محللين كشفت “حرب الأيام الاثني عشر” عن مدى حساسية الجبهة الداخلية، وعن الحاجة الملحة لحماية التنوع السياسي والاجتماعي من محاولات التصفية أو التوظيف، إذ أن استقرار ما بعد الحرب لا يُبنى فقط بالهدوء، بل بترميم الثقة واحتواء الاختلاف، لمنع أي اختراق جديد قد يأتي على شكل نصيحة أو شعار.
3- التطرف: تهديد داخلي لاستقرار الدولة
يحذر محللون من أن عدم الثقة في القوى الإصلاحية والمعتدلة داخل البلاد لا يعكس حرصًا ثوريًا، بقدر ما يعكس تمسكًا بالرأي الآخر يهدد التماسك الداخلي. فقد أثبتت التجربة أن التطرف وسياسات الإقصاء تُضعف الجبهة الداخلية أكثر مما قد يفعله العدو الخارجي. وفي هذا السياق، يدعو الكاتب منتجبي إلى تحكيم العقل وربط السياسة بالحكمة، وموازنة العاطفة بالتفكير في مصلحة الأجيال القادمة، حيث يرى أن التطرف يؤدي إلى تغييب العقلانية، ويُفسح المجال للمشاعر الانفعالية أن تُحدد مصير القرارات الاستراتيجية، مما يُفقد الدولة توازنها، ويُضعف ثقة الناس في مؤسساتها، ويشوّه صورة الحكم في نظر الرأي العام.
سابعًا: إثراء التضامن الوطني: حزمة من الوجوبيات لما بعد الحرب
في تحليلها للوضع الداخلي الإيراني بعد الحرب، تدعو الكاتبة الصحفية معصومة ابتكار إلى البناء على حالة التضامن الوطني التي برزت خلال الحرب، وعدم تركها تتبدد في ظل تحديات ما بعد الصراع. وترى أن تعزيز هذا التماسك يتطلب ما وصفته بـ”حزمة من الوجوبيات الكبرى”، وهي مجموعة من الخطوات العملية التي يجب على الدولة والمجتمع اتخاذها لتثبيت الوحدة وتعزيز الثقة.
تبدأ هذه الوجوبيات بإعادة بناء ثقة الناس بالإعلام الوطني، من خلال احترام تنوع الآراء والأذواق، بما يعيد إليه مكانته كمصدر موثوق. يلي ذلك ضرورة احترام حقوق المنتقدين، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين ورفع القيود، بل وحتى مناقشة العفو العام كخطوة رمزية تعزز المصالحة.
وتشدد ابتكار على أهمية رفع القيود عن منظمات المجتمع المدني، التي تأثرت سلبًا بسياسات التضييق السابقة، وإعادة تفعيل دورها في تعزيز المشاركة المجتمعية. كما تبرز الحاجة إلى فتح قنوات حوار حقيقي مع الشباب، عبر الجامعات والمنصات المفتوحة، لتحويل اللامبالاة إلى مشاركة فاعلة في رسم مستقبل البلاد.
وتشمل المقترحات أيضًا تفعيل الحياة الحزبية، ورفع القيود عن الأحزاب ذات التوجه النقدي، وخلق بيئة سياسية تسمح بالمشاركة والتعدد. كما دعت إلى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لا سيما النساء المعيلات والأسر ذات الظروف الخاصة، من خلال برامج تمكين ورعاية مستدامة، كما تؤكد ابتكار أن مكافحة الفساد في الأجهزة المالية والمصرفية والقطاعات الريعية يجب أن تكون أولوية، لأن هذه النقاط تمثل ثغرات استراتيجية يستغلها الخصوم، وتُضعف مناعة الدولة.
وفي خلاصة التحليل، تدعو إلى استثمار فرصة الهدنة لمراجعة الذات، وترميم الانقسامات الداخلية، والحفاظ على ما تحقق بالتضحيات، مؤكدة أن إيران تقف اليوم أمام لحظة فاصلة لا يجب التقليل من إنجازاتها، ولا التغاضي عن تحدياتها. إنه وقت لليقظة الشاملة، وبناء أسس واقعية لمستقبل أقوى وأكثر تماسكًا.
وختامًا يمكن القول.. تشير التجربة التاريخية، كما في أطروحات منظرين أمثال تشارلز تيلي، إلى أن قدرة الدولة الحديثة لا تُقاس فقط بامتلاك أدوات القوة، بل بمدى كفاءتها في إدارة الحرب والسلم، وتعبئة مواردها البشرية والمادية ضمن مشروع سياسي جامع.
في ضوء ذلك، تُطرح المرحلة التي تلي الحروب بوصفها اختبارًا حقيقيًا للدول، حيث لا يكفي الانتصار العسكري ما لم يترافق مع تحولات بنيوية في العلاقة بين السلطة والمجتمع. ويبدو أن المرحلة الراهنة، في الحالة الإيرانية، تضع أمام الدولة تحديًا مركزيًا: هل ستُستثمر نتائج المواجهة في فتح أفق جديد لإصلاح داخلي يعيد بناء الثقة، ويعزز من شرعية المؤسسات، أم يعاد إنتاج ديناميكيات ما قبل الحرب؟